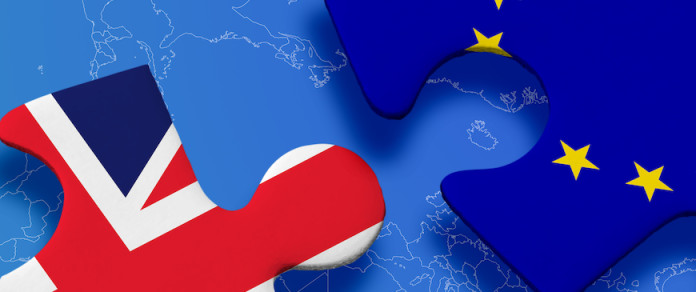ماتياس ماتيس: هو أستاذ مساعد في الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة.
تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأسوأ أزمة سياسية يمرُّ بها الاتحاد منذ أي وقت مضى، إذ منذ بداية الخمسينيات توسع الاتحاد بنحوٍ مطرد، ولكن في الثالث والعشرين من حزيران تجاهل 52% من الناخبين البريطانيين تحذيرات الخبراء حول الكارثة الاقتصادية وفضلوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطانيين في شهر تشرين الأول، قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وعوداً بتفعيل المادة 50 ببدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وتحديد مهلة عامين لمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول شهر آذار من عام 2017. ونظراً لعزمها في استعادة السيطرة على الهجرة ورغبة زعماء الاتحاد الأوروبي في جعل المملكة المتحدة مثالاً سيئاً لما يسمى بالخروج البريطاني الصعب -مغادرة السوق والاتحاد الكمركي الموحد- أصبح ذلك أمراً مرجحاً بنحوٍ متزايد، فهذا الأمر يجب أن يضع حداً للفكرة المهيمنة في أن التكامل الأوروبي هو عملية لا رجعة فيها.
حينما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي فمن شبه المؤكد أن الاتحاد سيفقد أكبر قواتها العسكرية، وأحد العضوين اللذين يمتلكان أسلحة نووية، وأحد العضوين ذا العضوية الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، وثاني أكبر اقتصاد الذي يمثل 18% من إجمالي الناتج المحلي و13% من سكانها، ومركزه المالي العالمي، وستخسر المملكة المتحدة أكثر من ذلك بالتأكيد، إذ إن 44% من الصادرات البريطانية تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي بينما 8% فقط من صادرات الاتحاد الأوروبي تتوجه إلى المملكة المتحدة، وستضطر المملكة المتحدة بقبول عروض لا تناسبها حينما تتفاوض على الصفقات التجارية والاستثمارية في المستقبل، فضلاً عن فقدان حق المواطنين البريطانيين في الدراسة، والعيش والعمل والتقاعد في دول الاتحاد الأوروبي، وما هو أكثر من ذلك أن عملية مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الذي استمر 44 عاماً سوف تستهلك الموارد البشرية والمالية بنحوٍ كبير، ولكن الشعب البريطاني قد اتخذوا قرارهم، وسيكون من الصعب -إن لم يكن من المستحيل- تغيير ذلك القرار.
أمّا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن توقيت الخروج البريطاني لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، فبعد أن تعرضت منطقة اليورو لأزمة الديون لأكثر من سبع سنوات، كانت الاقتصادات الأوروبية لا تزال هشة، وأن اثنتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي -المجر وبولندا- تتجهان بنحو سريع للديمقراطية غير الليبرالية.
كشفت أزمة اللاجئين عن انقسامات عميقة بين دول الاتحاد بشأن الهجرة، ويبدو أن الأزمات في أوروبا لا تنتهي، فقد حظيت الأحزاب المناهضة للمؤسسة -سواء الأحزاب اليمينية أم اليسارية- التي شككت في أهمية الاتحاد الأوروبي بشعبية كبيرة، وذلك على حساب الأحزاب المسيحية الديمقراطية والأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، الذين لم يترددوا في دعم استمرارية الاتحاد الأوروبي.
في معاهدة روما عام 1957 -التي أسست للاتحاد الأوروبي- اعتقد زعماء أوروبا بأن هذه الاتفاقية ستوثق العلاقات بين شعوب أوروبا بنحوٍ أكبر منذ أي وقت مضى بعد مرور ستة عقود، وبدا وكأن هذا الاعتقاد قد عفى عليه الزمن.
تعزى جذور الأزمة الحالية في الاتحاد الأوروبي إلى فترة الثمانينيات، إذ في العقود الأربعة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، رأى قادة مشروع الاتحاد الأوروبي أنها وسيلة لاستعادة الشرعية السياسية للدول التي مزقتها الحرب، ففي الثمانينيات كان لدى النخب في أوروبا هدفاً أسمى هو صياغة النظام الإقليمي الاقتصادي الذي يتجاوز الحدود الوطنية، والذي سيتيح للقوة التكنوقراطية المستنيرة بالسيادة.
إن إنشاء سوق موحدة في عام 1986، ومن ثم إدخال العملة الموحدة بعد عقد من الزمن قد بشر بعهد جديد وعظيم للنمو الاقتصادي والتكامل السياسي.
زرعت تلك الإجراءات بذور الأزمة الحالية في أوروبا، إذ فشل القادة الأوروبيون بإنشاء المؤسسات الضرورية التي تجعل كلاً من السوق والعملة الموحدة تعملان بنحوٍ صحيح، وأنشأوا اتحاداً نقدياً بين الدول دون وجود اتحاد مالي وضريبي؛ مما أدى إلى الانهيار المالي لدول مثل اليونان وإيطاليا بعد كساد عام 2008. في يومنا هذا يعد اقتصاد اليونان أصغر بنسبة 26% عما كانت عليه في عام 2007، ولا تزال غارقة في الديون، وقد وصلت نسبة بطالة الشباب إلى أقل بقليل من 50%. أمّا في إسبانيا فتصل نسبة بطالة الشباب إلى أكثر من 45%، وحوالي 40% في إيطاليا. افترض زعماء أوروبا بنحو دائم أن الأزمات من شأنها أن تؤدي في المستقبل إلى وجود تكامل أكبر بين الدول الأوروبية، ولكن الأزمة الاقتصادية تليها أزمة سياسية مستمرة بشأن الهجرة أديا إلى وصول الاتحاد الأوروبي إلى حافة التفكك.
إذا أراد الاتحاد الأوروبي الاستمرار بالبقاء على قيد الحياة، فيجب عليه استعادة التقسيم الأصلي للعمل بين العواصم الأوروبية وبروكسل، حيث احتفظت الحكومات الوطنية بحرية التصرف في المجالات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، مثل القدرة على تقديم الحوافز المالية، والدفاع عن الشركات الوطنية المتفوقة.
إن الاتحاد القومي وجد ليبقى، والسياسات الوطنية لا تزال لديها الشرعية الديمقراطية التي هي أكبر بكثير من تلك التي يفرضها التكنوقراط في بروكسل أو فرانكفورت، ويتعين على الاتحاد الأوروبي إعطاء الحكومات الوطنية في أوروبا حرية التصرف بنحوٍ أكبر.
من الرماد:
إن مؤسسي الاتحاد الأوروبي حزينون لمعرفة ما أصبح عليه حال الاتحاد الآن، كما أكّد المؤرخ البريطاني آلان ميلوورد في كتابه عام 1992 “The European Rescue of the Nation-State”. أنشأت النخب الحاكمة في أوروبا في الخمسينيات السوق الأوروبية المشتركة (EEC)، ولم تنشأها لبناء قوة تتجاوز الحدود الوطنية ولكن لإعادة تأهيل النظام في الدول الأوروبية بعد أهوال الحرب العالمية الثانية، إذ أدركوا أنهم إذا أرادوا استمرارية بلدانهم فيجب أن يكون هناك قدر من التنسيق القاري للمساعدة في توفير الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
قال ميلوورد إن زيادة التعاون الأوروبي يتطلب بعض التنازلات في السيادة، ولكن ليس باستبدال الدول الاعضاء في الاتحاد مع شكل جديد من أشكال الحكم التي تتجاوز الحدود الوطنية، بل تم إنشاء السوق الأوروبية المشتركة (EEC) تماشياً مع فكرة “الليبرالية غير المتجزئة”: إذ تم الإجماع ما بعد الحرب أن الدول ذات السيادة سوف تتحرر اقتصاداتها تدريجياً ولكن مع الحفاظ على حرية التصرف حول السياسات الاقتصادية للتعامل مع الأزمات المحلية.
ترك الآباء المؤسسون للسوق الأوروبية المشتركة (EEC) معظم القوى السياسية والاقتصادية تحت سيطرة الحكومات الوطنية، ومنحوا مهمة تنسيق إنتاج الفحم والصلب والدعم الزراعي والبحوث النووية فضلاً عن العلاقات التجارية الداخلية والسياسات الاقتصادية الخارجية المشتركة تحت سيطرة السوق الأوروبية المشتركة (EEC).
كانت نتائج الاتحاد الأوروبي في العقود الثلاثة الأولى تبشر بالخير من طريق السلام والاستقرار والازدهار وتعزيز زيادة التجارة، في بداية التسعينيات، وحينما نشر ميلوورد كتابه وصل الاتحاد الأوروبي إلى ذروة نجاحه، ففي عام 1991 وعلى وفق استطلاعات يوروباروميتر (Eurobarometer) فإن حوالي 71% من مواطني الاتحاد الأوروبي رأوا أن عضوية بلادهم في الاتحاد هو “شيء جيد”، في حين أن 7% فقط اعتقدوا أنه كان “سيّئاً”.
في منتصف الثمانينيات، بدأت النخب في أوروبا بتحويل طبيعة المشروع السياسي الأوروبي بقيادة جاك ديلور -رئيس المفوضية الأوروبية- وبدعم من الرئيس الفرنسي -فرانسوا ميتران- والمستشار الألماني -هيلموت كول- بإنشاء أنموذج جديد للحكم خارج الحدود الوطنية، بدلاً من استخدام الاتحاد الأوروبي لتعزيز النظام القديم للقارة الأوروبية في توحيد دولها.
إن الأحكام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لها الأسبقية على التقديرات السياسية الوطنية، وأدى التكامل الاقتصادي بين الدول الأوروبية إلى عرقلة السياسة الديمقراطية المحلية. إن رؤية الفيدرالية الخاصة بجاك ديلور تتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التخلي عن السيادة، وإضعاف الروابط المتميزة التي كانت تجمع بين الحكومات الوطنية وشعوبها بنحوٍ تدريجي؛ وبالتالي فإن العضوية في الاتحاد الأوروبي لم يعد ينطوي على تفعيل مبدأ (الدولة القومية) بل تقييد سيادة الدول الأعضاء.
التجربة العظيمة:
كانت أول نقطة تحوّل في مسار المشروع السياسي الأوروبي في عام 1986، حينما اتحد الاشتراكيون الفرنسيون مثل ديلور وميتران مع المحافظين مثل كول ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر في التوقيع على القانون الأوروبي الموحد (SEA). ويُعَدُّ القانون الأوروبي الموحد ردة فعل على (Eurosclerosis) -تَشَنُّج أسواق العملة بسبب انعدام السيولة أو الذعر المالي- في السبعينيات والثمانينيات؛ نتيجة النمو المنخفض الذي طال أمده، واضطرابات العمالة، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، أنشأت معاهدة روما السوق المشتركة وتضمنت على “الحريات الأربع” في القانون الأوروبي: حرية تنقل الأفراد، والخدمات، والبضائع، ورؤوس الأموال، إلّا أن الأنظمة الوطنية التي لا تُعَدُّ ولا تحصى لا تزال تقيد التجارة عبر الحدود، وجادل صانعو السياسة الأوروبيون أنه للهروب من الركود الاقتصادي يجب رفع القيود وتحرير التجارة، وبالفعل -بحلول عام 1992- أصبحت السوق الأوروبية المشتركة سوقاً واحداً أصيلاً.
جذور الأزمة الحالية للاتحاد الأوروبي يمكن أن تعزى إلى فترة الثمانينيات:
كما حذّر عالم الاجتماع الاقتصادي المجَري -كارل بولاني- في منتصف القرن العشرين، بأن هناك أمراً غير مـألوف حول إنشاء السوق المشتركة، إذ إنها تتطلب قوانين كبرى تصدر من سلطة الدولة، وذلك أن الأنشطة التي كانت “مضمنة” في العلاقات الاجتماعية والسياسية المحلية ستصبح من السلع القابلة للتداول بين جهات مجهولة، ويجب على عملية التبادل أن “تنتزع” من سياقها الاجتماعي لتصبح صفقات في السوق، كان القانون الأوروبي الموحد من العمليات الكبرى في انتزاع أسواق البلدان من الحماية والقوانين والتقاليد الوطنية.
كان القانون الأوروبي الموحد (SEA) طموحاً للغاية، إذ كانت معظم البلدان الأوروبية تطلب من شعوبها الحصول على التراخيص الوطنية حينما يقدمون الخدمات كتصميم المنازل، أو إجراء العمليات الجراحية، أو تقديم المشورة المالية، وكانت العديد من الحكومات لا تزال تراقب وتحد من رأس المال والتدفقات المالية من وإلى السلطات القضائية الوطنية، وكانت جميع أنواع القيود غير الجمركية مثل: الصحة الوطنية، والسلامة والمعايير البيئية لا تزال تقيد التجارة الدولية للسلع، ولكن بعد القانون الأوروبي الموحد (SEA)، أصبح بإمكان المواطنين الأوروبيين التنقل بسهولة بين أسواق العمل الوطنية، وأصبحت رؤوس الأموال تتدفق بحرية عبر الحدود الأوروبية، وأصبح بإمكان طيار برتغالي أن يقود طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، وبإمكان بنك بلجيكي أن يستثمر في اليونان، وبإمكان سائق ألماني شراء سيارة اللامبورغيني الإيطالية دون الحاجة إلى القلق فيما إذا كان ينطبق عليها المعايير التقنية والسلامة في ألمانيا، إلّا أن السوق الموحدة لم تكن مكتملة بالكامل، لافتقارها للنظام الموحد للإشراف على أكثر البنوك أهمية في أوروبا كما افتقرت لآليات التحذير من الانقطاع المفاجئ لتدفقات رأس المال.
لاحظ علماء السياسية -ليف هوفمان وكريج بارسونز- أنه في كثير من الحالات، كان لدى السوق الموحدة في الولايات المتحدة الأمريكية أنظمة أكثر من نظيرتها في أوروبا، وفيما يتعلق بالمشتريات العامة -مثلاً- تعطي ولاية كاليفورنيا أو مدينة شيكاغو الأفضلية لمقدمي الخدمة المحليين، في حين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليس بإمكانهم تفضيل الشركات الوطنية، وأن عملية تنظيم سير الخدمات في الولايات المتحدة يحدث في الولاية نفسها وليس على المستوى الاتحادي، -فمثلاً- يجب على مصفف الشعر المرخّص الذي ينتقل من ولاية أوهايو إلى ولاية بنسلفانيا أن يخضع لــ(2100) ساعة تدريبية، واجتياز امتحان عملي ونظري للحصول على ترخيص جديد، بينما بإمكان مصفف الشعر من برلين إنشاء محل للحلاقة في باريس في اليوم التالي من سفره، ولكن تجربة الاتحاد الأوروبي في خلق سوق حرة حقيقية قد حدثت بعد دفع الثمن.

إن ازدياد المنافسة في السوق التي أدخلها القانون الأوروبي الموحد قد جلب منافع واسعة النطاق، ولكنه أيضاً تسبب بوجود الفائزين والخاسرين، إذ يواجه المنتجون المحليون ومزودو الخدمات في فرنسا أو المملكة المتحدة منافسة قوية من الشركات المصنعة للمنتجات السلوفاكية، والسباكين البولنديين، والمقاولين الرومانيين الأرخص سعراً، ففي سنوات الازدهار حصدت الاقتصادات أوروبية ثروة كافية لتعويض الخاسرين، ومع ركود الاقتصاد، بدأت مجاميع واسعة من الناخبين الوطنيين بالمطالبة بمزيد من الحماية من السوق التي بناها الاتحاد الأوروبي.
بسبب قيام القانون الأوروبي الموحد (SEA) باقتلاع الأسواق الأوروبية من السياسة الديمقراطية القائمة على الصعيد الوطني، والمؤسسات الاجتماعية، صبّت الحكومات الأوروبية جلّ اهتمامها بالتدخل في اقتصادات بلدانهم. وحدث هذا -إلى حد ما- بسبب العولمة التي انتشرت في كل مكان، إلا أن الدول الأوروبية قامت بمنح الأولوية للأسواق الدولية على سياساتها المحلية؛ ونتيجة لذلك، فقدوا السيطرة على اقتصاداتهم المحلية مقارنة مع نظرائهم الغربيين، ولأن الموافقة على الأنظمة المتعلقة بالسوق الموحدة التابعة للاتحاد الأوروبي لا تتطلب سوى الحصول على موافقة أغلبية الدول الأعضاء، بدلاً من الإجماع عليها ليصبح قانوناً، فإنها -في بعض الأحيان- تتعارض بنحوٍ مباشر مع المصالح الوطنية، فمثلاً في آب عام 2016، أمر الاتحاد الأوروبي الحكومة الآيرلندية بجمع 14.5 مليار دولار نتيجة للضرائب غير المدفوعة لشركة أبل، على الرغم من احتجاجات الحكومة الآيرلندية التي صرحت بأن الضرائب المنخفضة للشركات تُعد عنصراً رئيساً في أنموذجها الاقتصادي ومسألة أساسية “للسيادة”.
الأزمة قادمة لا محالة:
يُعدُّ إصدار عملة اليورو الجديدة على وفق معاهدة ماستريخت في عام 1992 خسارة كبيرة لسلطة الحكومات الوطنية في أوروبا، إذ اقترحت النُخَب في أوروبا عملة اليورو لأنها اعتقدت بأن السوق الموحدة ستعمل بنحوٍ سليم بوجود عملة واحدة، وقالت أيضاً إن البلدان الموحدة مثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيستفيدون من عملية إنهاء تقلبات أسعار الصرف مع بعضها بعضاً، وحلمت هذه النخب بإصدار عملة مشتركة يمكن أن تتحدى التفوق العالمي للدولار الأمريكي.
إن تجربة الاتحاد الأوروبي في خلق سوق حرة حقيقية كان لها ثمن غالٍ:
إن عملة اليورو لم تمنح لديمقراطيات أوروبا أي حرية تذكر، إذ إن إدخال العملة الموحدة الجديدة والبنك المركزي الأوروبي -الذي لديه مهمة وحيدة وهي الحفاظ على استقرار الأسعار- قد منعتا الدول الأعضاء من مواصلة سياساتها النقدية، وكان لمتطلبات التقشف المالية -التي أصرت عليها ألمانيا- دور كبير في جعل عملية تحفيز النمو الاقتصادي صعباً على حكومات أوروبا من خلال زيادة الإنفاق خلال فترة الركود.
اهتم ميثاق الاستقرار والنمو عام 1997 بحل مشكلة العجز العام المنخفض وانخفاض نسب الديون السيادية، ولكن الاسم الذي سمي به الميثاق يعد تسمية خاطئة، إذ قام الميثاق بتقويض الاستقرار الاجتماعي ولم يقم بأي تأثير يذكر فيما يتعلق بالنمو.
تعد ألمانيا المستفيد الأكبر من إصدار عملة اليورو؛ وذلك لأن قيمة العملة الألمانية لم يكن بإمكانها الارتفاع مقارنة مع عملات شركائها التجاريين الأوروبيين، وتحفظت ألمانيا عن ذكر التكلفة الحقيقية لصادراتها؛ مما أدى إلى حدوث الفائض التجاري الهائل، لكن عملة اليورو كانت أمراً كارثياً بالنسبة لبقية أوروبا، واعتقد زعماء أوروبا أنه ليس من الحكمة إقامة اتحاد مالي وسياسي حقيقي لاستكمال الوحدة النقدية، إذ توقعوا أن ناخبيهم لن يقبلوا بذلك، وافترضوا أن الأزمات سوف تدفع الاتحاد الأوروبي نحو مزيدٍ من التكامل في المستقبل، وقد صرّح رومانو برودي -رئيس الوزراء السابق لإيطاليا ورئيس المفوضية الأوروبية- في عام 2001 -عشية إطلاق عملة اليورو- بقوله: “أنا واثق من أن عملة اليورو قد تضطرنا إلى تقديم مجموعة جديدة من أدوات السياسة الاقتصادية، وهو من المستحيل سياسياً أن يتم اقتراحها الآن، ولكن في يوم من الأيام سوف تكون هناك أزمة وسيتم تقديم أدوات السياسة الاقتصادية الجديدة”.
ولكن حينما حدثت الأزمة المالية، رفض البنك المركزي الأوروبي في بداية الأمر تخفيف السياسة النقدية بل قام برفع أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه، لم يكن بإمكان الحكومات الوطنية خفض قيمة عملاتها المرتبطة بالشركاء التجاريين الرئيسيين لتعزيز الصادرات، ولا إطلاق برامج التحفيز المالي، ولم يكن لديهم خيار سوى الرجوع لتدابير التقشف القاسية، وعلى المدى القصير، قامت ردة الفعل هذه بزيادة الأمر سوءاً، ومنذ ذلك الحين، أنشأ الاتحاد الأوروبي بعض الأدوات الجديدة -بما في ذلك الاتحاد المصرفي والاتفاق المالي الجديد- التي قامت بنقل مسؤولية الإشراف على أكبر البنوك في منطقة اليورو من أيدي السلطات الوطنية إلى البنك المركزي الأوروبي، ولكن فكرة التكامل الأوروبي ظلت نفسها لم تتغير وهي: (أنظمة تجاوز الحدود الوطنية، وتقدير أقل للسلطة المحلية)، على سبيل المثال، لا يمكن أن تتدخل الحكومة الألمانية لإنقاذ دويتشه بنك (Deutsche Bank)، الذي كان رمزاً للقوة المالية في ألمانيا، ولا يمكن للحكومة الإيطالية تشغيل العجوزات المالية الكبيرة لمواجهة النقص المزمن في النمو الاقتصادي.
أزمة التنقل داخل الاتحاد الأوروبي:
تتعلق هذه الأزمة بالهجرة التي تهدد بزوال الاتحاد، وكانت حرية تنقل الأفراد داخل سوق موحدة قضية سياسية غير مهمة، واعتبرها العديد على أنها فرصة للشباب للدراسة في الخارج من خلال برامج ايراسموس وسقراط التابعة للاتحاد الأوروب،ي وأن سهولة تنقل المتعلمين في الاتحاد الأوروبي تزيد من فرصة الحصول على الخبرة حين العمل في بلد أوروبي آخر، حتى السنوات الأُول من هذا القرن كانت مستويات الهجرة للاتحاد الأوروبي منخفضة جداً.
ولكن حينما توسّع الاتحاد الأوروبي في عام 2004 لتشمل الدول الشيوعية السابقة في وسط وشرق أوروبا، بدأت الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي بالنمو، وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 1989: إن توسيع الاتحاد الأوروبي من جهة الشرق خلق “أوروبا موحدة وحرة”، ولكنه أيضاً جعل عضوية الاتحاد غير متكافئة اقتصادياً، وحينما انضمت بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد حوالي 6600 دولار، وفي المملكة المتحدة بلغ الناتج المحلي الإجمالي 38300 دولاراً، وشجعت هذه الاختلافات الكبيرة في مستويات الدخل الملايين من الأوروبيين الشرقيين للتوجه إلى غرب أوروبا.
بين عامي 2004 و2014 انتقل أكثر من مليوني شخص من بولندا إلى ألمانيا والمملكة المتحدة، وما يقرب من مليون آخرين انتقلوا من رومانيا إلى إيطاليا وأسبانيا، وقد تسبب هذا الانتقال بالضغط على الخدمات العامة وشبكات الأمن في البلدان المستقبلة لهم.
في عام 2015 توجه أكثر من مليون مهاجر ولاجئ من أفغانستان، والعراق، وسوريا، وأفريقيا إلى أوروبا، ولم يكن هناك آلية للتعامل مع مثل هذه التحركات المفاجئة من الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي، ولم يكن لدى الاتحاد أي سياسة تتعلق بالهجرة الخارجية المشتركة للمساعدة في استيعاب تدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين.
إن الحكومات الوطنية -المقيدة بأنظمة الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق المالي وغير قادرة على الاتفاق على كيفية تقاسم الأعباء- قد عانت حين تعاملها مع هذا الوضع، ولا تزال أعداد الهجرة الشاملة منخفضة نسبياً، ومساهمة المهاجرين في البلدان المضيفة لهم تعد إيجابية في المقام الأول، ولكن يشعر العديد من المواطنين بأن حكوماتهم عاجزة وأن الاتحاد الأوروبي يفشل في تمثيل مصالحهم.
لا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أنظمة جديدة؛ بل بحاجة إلى القيادة السياسية:
قامت حكومات أوروبا الشرقية، مثل حكومة فيكتور أوربان في المجر والحكومة في بولندا بالدفاع بشراسة عن حقوق مواطنيها للعيش والعمل في الاتحاد الأوروبي في حين رُفِضَت طلبات الاتحاد الأوروبي باستقبال نسبة محددة من اللاجئين. العديد من الحكومات الأوروبية الغربية على استعداد بقبول نسبة من اللاجئين –على مضض- يحدددها الاتحاد الأوروبي ولكنهم يشككون بطبيعة الهجرة المتزايدة وغير المحدودة داخل الاتحاد الأوروبي. إن المخاوف من الهجرة غير محدود من دول مثل تركيا -المرشحة للحصول عل عضوية في الاتحاد الأوروبي- أدت دوراً رئيساً في قرار المملكة المتحدة لترك الاتحاد الأوروبي، والرغبة في استعادة السيطرة على الهجرة إلى المملكة.
استعادة السيطرة:
إلى أين يتجه الاتحاد الأوروبي؟ بينما كانت المملكة المتحدة العضو الأكثر تردداً بنحوٍ دائم حيال مستقبل الاتحاد، إلّا أن العديد من الأشخاص المحبين لليورو يميلون بالقول: إن بروكسل ستدفع الاتحاد نحو مزيدٍ من التكامل، ولكن ذلك سيكون قراءة خاطئة للوضع الحالي في عواصم أوروبا، وعوضاً عن ذلك، ينبغي على قادة أوروبا العودة إلى الفكرة الأساسية لميلوورد بأن لم يؤسس الاتحاد للسيطرة على الدول الأوروبية بل لإنقاذهم من الحرب، ولا تزال الحكومات الوطنية في أوروبا تمتلك الشرعية الديمقراطية، ولا يوجد هنالك حلول تكنوقراطية للمشكلات السياسية في أوروبا. يقول المؤرخ توني جودت في عام 1996: “لا أود أن أقول: إن المؤسسات الوطنية متفوقة على غيرها من المؤسسات”، وأضاف: “لكن علينا أن ندرك واقع الأمم والدول، ونلاحظ الخطر -حين يتم إهمالها- حينما تصبح مورداً انتخابياً للقوميين الأكثر خبثاً”.

قام الاتحاد الأوروبي بسحب العديد من الأدوات السياسية من الحكومات الوطنية الأمر الذي أدى إلى تساؤل المواطنين عن غرض وجود حكوماتهم، وكما قال مارك بليت -الاقتصادي السياسي- عن مستقبل اليورو: “دون تطوير العملية السياسية لتضمين شرعية المؤسسات الاقتصادية والمالية [في منطقة اليورو]، فإن مستقبل اليورو سيكون هشاً”.
إنّ استعادة النمو في منطقة اليورو، ومكافحة بطالة الشباب، وتشجيع الإصلاحات السياسية في الاتحاد الأوروبي -التي من شأنها أن ترجع بعض القوة الاقتصادية للدول الأعضاء- جميع تلك الأمور يجب أن يكون لها الأسبقية في معالجتها بدلاً من التطرق لحالة التقشف واعتماد الإصلاح الهيكلي الواحد لمعالجة جميع المشكلات.
يجب إضفاء الشرعية الديمقراطية للسياسات التوزيعية -التي تجعل بعض الجهات فائزة وبعضها الآخر خاسرة- من طريق الانتخابات الدورية؛ وبالتالي يجب أن تبقى حكراً تحت سيطرة الحكومات الوطنية، وتشمل هذه السياسات تحديد الأولويات في الميزانية، وتحديد مدى كرم دولة الرفاه، وتنظيم أسواق العمل، والسيطرة على الهجرة، وتوجيه السياسة الصناعية.
إن السماح للدول بكسر قواعد السوق الموحدة والعملة الأوروبية الموحدة في بعض الأحيان من خلال السماح لهم مؤقتاً بحماية الصناعات الرئيسية ودعمها مالياً، أو وضع قوانين طارئة للهجرة تحت ظروف صارمة معينة من شأنها أن تمّكن النخب الوطنية بالتعامل مع مشكلات وطنية محددة، والاستجابة لمخاوف الناخبين المشروعة من خلال منحهم الخيار الديمقراطي حول السياسة.
ينبغي أن يركز الاتحاد الأوروبي على الأمور التي ليس باستطاعة الدول الأعضاء القيام بها بكفاءة والتي تخلق مكاسب متبادلة، مثلاً: التفاوض حول اتفاقيات التجارة الدولية، والإشراف على البنوك ذات الأهمية والمؤسسات المالية الأخرى، والاستجابة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتنسيق السياسة الخارجية والأمن، ففي استطلاعات قام بها يوروباروميتر (Eurobarometer polls)، فإن حوالي ثلثي المواطنين الأوروبيين -ممن شملهم الاستطلاع- يدعمون باستمرار السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وبإمكان الحكومات الوطنية البدء بضم مواردهم العسكرية لإجراء حملات مشتركة لحفظ السلام وحماية حقوق الإنسان في الخارج.
لا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أنظمة جديدة، بل هو بحاجة إلى القيادة السياسية، فعلى ألمانيا التخلي عن معارضتها لسندات اليورو، أو لأدوات الدَين في منطقة اليورو المكفولة بنحوٍ مشترك، والتأمين على الودائع المشتركة، التي من شأنها أن توفر الاستقرار المالي على المدى الطويل في منطقة اليورو من طريق منع انتشار عدوى سوق السندات وإفلاس البنوك في المستقبل، ويجب على ألمانيا أيضاً التخفيف من إصرارها على القواعد المالية الصعبة للسماح لدول مثل إيطاليا والبرتغال بالمشاركة في تحفيز الطلب الكلي، ويجب أن تأخذ زمام المبادرة في وضع آليات جديدة لتعزيز التضامن داخل الاتحاد الأوروبي، مثل صندوق الهجرة المشترك لمساعدة اللاجئين، الذي يمكن أن يعوض الفارق في العجز المؤقت في التمويل المحلي ومساعدة دول الأعضاء بالمشاركة بنحوٍ فعال في رفع عبء توزيع المهاجرين الجدد في جميع أنحاء أوروبا.
يجب على ألمانيا احتضان دورها القيادي، فإذا تمكنت من التغلب على ضيق أفق توقعاتها والاعتراف بوجود فائدة لها على المدى البعيد بأن تكون القوة المهيمنة في أوروبا -ولا يختلف عن الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في العالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية- فلا يوجد أي سبب لعدم ظهور الاتحاد الأوروبي بصورة أقوى من ذي قبل، وعلى قادة الدول الكبرى مثل: فرنسا، وإيطاليا، وبولندا، وإسبانيا، طمأنة برلين بأنهم ملتزمون بإصلاح اقتصادها بمجرد عودة النمو، والتعهد بأن يساهموا بنحو فعّال لضمان التكامل في الاتحاد الأوروبي، وأن يؤكدوا مرة أخرى أن المشروع الأوروبي هو من مصالحهم الوطنية؛ وبالنتيجة يحتاج قادة أوروبا -جميعهم- إلى إعادة تأكيد الغرض من الاتحاد الأوروبي واستعادة السيطرة على عملية التكامل الأوروبي، فقد مضى ستون عاماً على التوقيع على معاهدة روما، وأوروبا بحاجة ماسة إلى صفقة جديدة كبرى أكثر مما مضى.
المصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2016-12-12/europe-after-brexit