أوليس سمولانسكي وبتي سمولانسكي
هو من أوائل الدراسات الموسعة التي تناقش العلاقات بين العراق والاتحاد السوفيتي، يقع الكتاب في (347) صفحة، ألفه الباحث أوليس سلومانسكي باللغة الإنجليزية بمساعدة بتي سلومانسكي، وقد قضى أوليس سلومانسكي مدة تتعدى عشرة أعوام في تقصي المصادر الغربية والعربية والسوفيتية لتأليف الكتاب، وقد حلل سمولانسكي -البلولندي الأصل والأميركي الجنسية- طبيعة العلاقات السوفيتية – العراقية، ويعمل البروفسور أوليس سمولانسكي أستاذاً في العلاقات الدولية في جامعة ليهي[1] الأميركية في ولاية بنسلفانيا، والباحثان متخصصان في العلاقات الدولية والشرق الأوسط والاتحاد السوفيتي السابق ولاسيما في دراسة النفوذ والتأثير بين الدول، واستخدم الباحثان هذه العلاقات كمادة دراسة لنفوذ القوى العظمى ومساحات التأثير، والتأثير المتبادل بينها وبين بلدان أصغر وأضعف، ويحفل بالكثير من التفاصيل عن طبيعة العلاقات بين بغداد وموسكو خلال الأعوام 1958-1980، ومعلومات عن الأسلوب الذي انتهجه حزب البعث وبالتحديد في تجربته لحكم العراق في بحثه عن حليف قوي لتثبيت وضعه داخلياً وإقليمياً ودولياً.
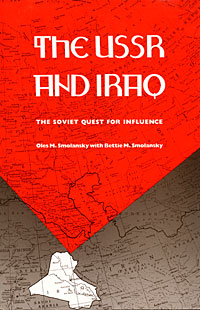
نشرت الكتاب دار نشر جامعة ديوك الأميركية عام 1991 ويُعَدُّ من الكتب النادرة في مجال بحثه ويضع القارئ في الصورة حول كيفية صياغة العراق لسياساته ضمن إطار النفوذ الدولي خلال الأعوام التي يغطيها الكتاب.
عرض ملخص لموضوعات الكتاب:
يركز الكتاب على ثلاثة موضوعات مترابطة كما يراهما المؤلفان، وهي: (العراق، والاتحاد السوفيتي، وعلاقات النفوذ)، ويناقش -بشيء من التفصيل- تأريخ العلاقات العراقية – السوفيتية التي يصفها بالمعقدة، وثنائية الاتجاه، ويجعل هذه العلاقات مثالاً لفهم علاقات النفوذ بين البلدان.
يستعرض الكتاب مفاهيم متعددة للنفوذ، ولكنه يصل إلى استنتاج مفاده أن النفوذ يتحرك في أفق تأثير قوة على قوة أخرى من غير استخدام القوة المسلحة، ولكنه يتوسع ليقول إن علاقات النفوذ هي علاقات متبادلة يتأثر بها الطرفان، وليس بالضرورة أن تكون باتجاه واحد لصالح الطرف الأقوى في العلاقة، ويضيف الكتاب أن العلاقات التي تعتمد على قوة أحد الطرفين على الآخر[2]غالباً ما تكون غير مستقرة وتحمل في طياتها “عمليات” لإحلال التوازن فيها من أحد الطرفين أو كليهما، وكمثال على علاقة افتراضية بين طرفين هما: أ و ب، حيث يمثل ب الطريق الذي يسعى لمد نفوذه على الطرف أ، إذ إن هنالك العديد من العمليات التي تشهدها العلاقة بناءً على أساس تخفيض التكاليف فيها، وهنا يلاحظ وجود أربع حالات يقوم من خلالها الطرف أ الذي يعتمد على الطرف الآخر بالعمل عليها:
- السعي للتوصل إلى تحقيق هدف الحصول على موارد لا تتوافر لديه أو لا يمتلكها مثل القاعدة الصناعية أو القوة العسكرية من الطرف ب.
- يحاول تجنب أضرار سلبية يتعرض إليها مثل خسارته أراضي أو هزيمة في نزاع مسلح.
- استغلال الطرف ب لتحقيق أهداف سياسية مستقبلية، من خلال تأييده في قضية يعد فيها الطرف أ محايداً، ولا يكبده تأييده أي خسائر تذكر، ولكنه في الوقت نفسه يضمن تأييد الطرف ب في قضاياه السياسية، من خلال كسب ثقته.
- يرفض الطرف أ بنحوٍ أساس بعض السياسات التي يراها تضرُّ بمصالحه الوطنية التي تفرض عليه من الطرف ب، ولكنه يستجيب للضغوطات والتهديدات التي تفرض عليه من الطرف ب.
ويبدو أن النفوذ أو التأثير ليس ذا وجه واحد وإنما متعدد الأوجه، ودائما ما تسعى الأطراف التي تمارس النفوذ على الدول التي تقبل به إلى التأثير على صناعة القرار ورسم سياسات محددة تصبُّ في مصلحة الدولة صاحبة النفوذ؛ وهكذا يعرف الكتاب النفوذ بأنه أي فعالية تقوم بها دولة ما (ب) تتسبب أو تساعد في التسبب في أفعال الدولة الأخرى (أ)؛ من أجل تحقيق أمنيات الدولة صاحبة التأثير (ب).
هنالك نوعان أساسيان من النفوذ هما: الأول: نفوذ التيسير[3]، والآخر: النفوذ المبادر[4]. يسعى الأول إلى أن تمنح القوة المؤثرة القوة الأصغر التي تخضع للتأثير بعض الموارد للسماح لها بأن تتبنى سياسات يحكم عليها أنها في صالح الطرفين، وهو نفوذ بناء يتعلق بالأهداف وخيارات السياسات.
أما النفوذ المبادر فيتعلق بأن تقوم القوة المؤثرة المؤثرة بمنح بعض الموارد للقوة الأصغر من أجل تبني سياسات عادة لا تقوم بتبنّيها، وهو نفوذ يحمل صفة فرض الحماية، ويقسم هذا النوع من النفوذ على نوعين آخرين هما: نفوذ مبادر ذو طبيعة متعاونة، ونفوذ مبادر ذو طبيعة قسرية. وبنحوٍ عام فإن فهم الظاهر يجب أن يأخذ في الحسبان تعقيد النفوذ، ولا يمكن أن تفهم إلا من خلال تفكيك التحليل الى أساسيات ذات معنى. واختصاراً فإن أية قوة عظمى حينما تسعى لمد نفوذها في بلد آخر فإنها بذلك تقدم جزءاً من مواردها بنحوٍ مباشر أو غير مباشر للتحكُّم أو لاستغلال البلد الآخر. وتسعى القوى العظمى لمد نفوذها لأنه أحد الوسائل الأقل كلفة للحصول على منافع، ويتحرك مد النفوذ لتحقيق منافع عسكرية، واقتصادية، وسياسية، وتصبح الأجندة الخفية في هذا النوع من العلاقات ليست بالضرورة بأن تحقق منفعة إيجابية للقوة صاحبة النفوذ، بقدر السعي إلى منع المنافع عن القوى المتنافسة معها، ومع التكلفة المضنية لرعاية عدد كبير من البلدان تحت مظلة النفوذ، فإنه -أيضاً- يكون من الصعب إرضاء جميع تلك البلدان الواقعة تحت النفوذ، ولاسيما في ظل توزيع المنافع والتنافس عليها، ولكن كيف يمكن تحديد ما إذا كان النفوذ يحقق النجاح أم لا؟ إذ إن من المؤشرات المهمة على تحقيق النجاح هو عقد المعاهدات، ومنح قواعد عسكرية للدولة الراعية، وتواجد قوات على أراضي البلد، ووجود مستشارين عسكريين، ونقل السلاح على نطاق واسع، ومن المؤشرات الأخرى أيضاً وجود مستويات من المساعدات الاقتصادية، ووجود تبادل تجاري كبير، والتوافق حول التصويت في الأمم المتحدة، وتبادل الزيارات على مستوى عال، فضلاً عن البيانات المشتركة التي تصاغ بطريقة مناسبة ، يبقى أن يشار أيضاً إلى أن النفوذ السوفيتي على العراق كان يختلف في منهاجه وأهدافه عن سوريا، فقد ركز على سوريا في النطاق العربي – الإسرائيلي، بينما ركز على العراق في نطاق منطقة الخليج، ولم يُسمَح بأن يكون له دور مهم في النزاع العربي – الإسرائيلي.
العلاقات السوفيتية العراقية 1958-1980:
أصبح العراق بلداً جاذباً لاهتمام الاتحاد السوفيتي؛ بسبب تموقعه على الحافة الشمالية للخليج، وقد مثل الخليج أهمية كبيرة للنفوذ الغربي بسبب الموارد النفطية الكبيرة فيه، وقد انماز العراق من غيره من بلدان العالم الثالث -التي كانت تدور في أفق النفوذ السوفيتي- بأنه كان من البلدان القليلة التي توافرت على ثروات كان يمكن أن يشتري بها معدات صناعية وعسكرية سوفيتية مقابل العملة الصعبة، فضلاً عن الخطاب والسياسات المضادة للغرب التي تبنتها بغداد بعد انقلاب 1958.
تم تأسيس أول علاقات دبلوماسية بين العراق والاتحاد السوفيتي عام 1944، ولكنها قطعت في عام 1955، حينما قرر رئيس وزراء العراق حينها نوري السعيد قطع العلاقات مع موسكو؛ بسبب انتقاد الأخيرة لقرار العراق الدخول في حلف بغداد، وقد اعترفت موسكو بالحكومة التي شكلها عبد الكريم قاسم عام 1958 وقيام الجمهورية. ومع تصاعد الخلافات بين العراق ومصر التي كان يحكمها جمال عبد الناصر اصطفت موسكو مع العراق؛ بسبب بعض الإجراءات التي اتخذها الجنرال قاسم، ومنها السماح لعمل الحزب الشيوعي العراقي.
في عام 1959 عقد الجانبان العراقي والسوفيتي اتفاقية قدمت بموجبها موسكو 137 مليون دولار لتطوير الاقتصاد العراقي، وأعلن العراق انسحابه رسمياً من اتفاقية حلف بغداد عام 1960، ولكن العلاقات بين البلدين سرعان ما انكفأت ما بين الأعوام 1960 و1962؛ بسبب سوء العلاقة بين الجنرال قاسم والحزب الشيوعي العراقي، ولكن ذلك لم يمنع موسكو من الاستمرار في التعاون العسكري والاقتصادي مع بغداد إلّا أن هذه العلاقة ساءت مجدداً مع مجيء حزب البعث إلى السلطة عام 1963، وقمع الشيوعيين، حيث توقف التعاون بين البلدين، ولكن بعد انقلاب 1963، عاد الاتحاد السوفيتي لتزويد العراق بالسلاح عام 1964 مع توقف النظام عن ملاحقة الشيوعيين والعمليات العسكرية في المناطق الكردية، وقد أقدم الاتحاد السوفيتي على مساعدة العراق في تطوير حقوله النفطية عام 1967.
العلاقات ما بين 1968-1975:
عاد حزب البعث إلى استلام مقاليد الحكم عام 1968 في العراق، ويبدو أن الاتحاد السوفيتي لم يهمه كثيراً هذا التغيير إذْ عقد الحزبان -البعث والشيوعي العراقي- اتفاقاً بينهما بعدم العودة إلى النزاع الدموي كالذي حصل في 1963، مما أدى إلى توثيق العلاقات بين البلدين إلى درجة أصبح فيها الاتحاد السوفيتي واحداً من أهم مزودي العراق بالسلاح والمعدات العسكرية.
في بداية السبعينيات من القرن الماضي اتخذ حزب البعث قرارات لتثبيت حكمه في العراق وموضعة العراق كلاعب رئيس في شؤون المنطقة في الخليج وشرق منطقة الشرق الأوسط، وقد فهمت قيادة حزب البعث آنذاك أن الدعم السوفيتي يعدُّ أمراً مهماً لتحقيق هذا الهدف. داخلياً كانت المسألة الكردية وتأميم النفط الهاجسين الأساسين للنظام في حينها، وقد كان الدور السوفيتي مهماً في هذا المجال، لذا تم اسغلال ورقة الحزب الشيوعي العراقي الذي كانت تتعامل معه موسكو كمصلحة من مصالحها في العراق، وقد تحوَّل فيما بعد إلى قضية كان على حزب البعث أن التخلُّص منها، وعلى الرغم من الاختلافات في المصالح بين البلدين إلّا أن حزب البعث لم يرغب خلال المدة 1968-1975 في إثارة ضغائن السوفيت الذي كان يحتاج إلى دعمهم بشدة؛ لتثبيت حكمه في العراق، فقد اعترفت بغداد بالحكم الذاتي للأكراد عام 1971 وهي قضية كان يرغب السوفيت برؤيتها تتحقق على أرض الواقع، وقدّم حزب البعث ما عُرف بمسودة العمل الوطني كي يضمن الدعم السياسي له من قبل الحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد قبل الأول به فيما رفضه الثاني؛ مما ولد تأزماً حاداً في العلاقات بين بغداد والأكراد، وقد اصطف الاتحاد السوفيتي والشيوعيون العراقيون مع حزب البعث في نزاعه هذا خلال الأعوام 1972-1973، وضمن حزب البعث تأييد موسكو وحلفائها الشيوعيين في قراره الخاص بتأميم النفط. أما إقليمياً ودولياً فقد احتاج البعثيون الدعم السوفيتي لفتح آفاق العالم لهم؛ إذْ كان العراق يعاني من عزلة خانقة في منطقة الخليج؛ بسبب الأيديولوجية العسكرية المتشددة التي تبنتها الأنظمة المتعاقبة في بغداد، وقد كان تركيز الحكومة في بغداد على التنافس مع إيران، ومع شعور شاه إيران بأن يؤدي دوراً إقليمياً مهيمنا في المنطقة، ومع التأزم شبه المستمر في العلاقات بين العراق وإيران، فإن بغداد كانت تستشعر الحاجة لتحديث قواتها المسلحة وتطويرها، حيث كانت موسكو هي المصدر الأساس وربما الوحيد لأي تسليح متطور للجيش العراقي، لأسباب أهمها التشدد الذي كان يحمله حزب البعث في خطابه ضد الغرب.
تم توقيع اتفاقية صداقة وتعاون بين العراق والاتحاد السوفيتي عام 1972 -على وفق الأنموذج المصري عام 1971- في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والحقول الأخرى، وكان الشاغل الأهم لحزب البعث تأميم النفط؛ لأنه كان سيقوي وضع الحزب في العراق والعالم.
على مستوى استراتيجي لموسكو مثل موقع كل من العراق واليمن الجنوبي امتداداً سوفيتياً مناسباً للحافة الغربية من المحيط الهندي، ومع تطور العلاقات بين البلدين فقد أراد حزب البعث الحاكم آنذاك من خلال تقوية علاقاته مع الحزب الشيوعي السوفيتي أن يستفيد من خبراته في السيطرة على أجهزة الدولة التنفيذية، ولم يكن الحزب الشيوعي السوفيتي رافضاً لفكرة التقارب تلك.
فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقد دعمت موسكو توجه العراق لتأميم شركة النفط العراقية ومتعلقاتها؛ لأن هذا التأميم كان يصب في مصلحة السوفيت في ضرب مصالح الغرب الاقتصادية، وأيضاً كان سيوفر أرباحاً اقتصادية هائلة لهم عبر السيطرة على القطاع النفطي العراقي من خلال بيع المعدات والمكائن، التي كان يتوقع أن يدفع العراق أسعارها بالعملة الصعبة، ولكن موسكو لم تتمكن من الاستفادة عسكرياً من العراق كما كان متوقعاً، إذ لم يضع العراق منشآته العسكرية، ومنها المطارات وقاعدة أم قصر البحرية تحت تصرف الاتحاد السوفيتي، ومع دخول معاهدة 1972حيّز التنفيذ، فقد أقدم السوفيت على دعم العراق سياسياً واقتصادياً لتنفيذ قرار تأميم الصناعة النفطية العراقية، وتوسعوا في تقديم مساعدات عسكرية للبلد، في مقابل ذلك قدم العراق تنازلات في المسألة الكردية والحزب الشيوعي العراقي، وقد منح السوفييت موافقة محدودة على منشآته العسكرية الجوية والبحرية، وقد كانت المنفعة متبادلة للطرفين.
بدأت موسكو بالاستفادة مباشرة من تطبيق قرار تأميم النفط العراقي في 1 حزيران 1972، إذْ زار وزير الصناعة حينذاك طه الجزراوي العاصمة السوفيتية وتم توقيع عدد من الاتفاقيات، حيث نصت إحداها على أن يتم تسديد القروض السوفيتية على العراق بالنفط، وكنتيجة لذلك وفي عام 1974 وصل استيراد الاتحاد السوفيتي من النفط الخام العراقي إلى 4 ملايين برميل، ولكن العلاقات بين الطرفين لم تسر كما شاءت موسكو إذ إنه خلال العامين 1973 و1974 -ولأسباب تتعلق بأمور إقليمية متعلقة بقرار البلدان العربية- حظر تصدير النفط الذي بسببه تصاعدت أسعار النفط، مما سمح للعراق بأن يستفيد من العملة الصعبة في تطوير اقتصاده، حيث توجه العراق إلى شركاء تجاريين من الغرب لأسباب اقتصادية بحتة، ويبدو أن خسارة الاتحاد السوفيتي في هذا الأمر كان يتعلق بممارساتهم التجارية مع العراق، فالعراقيون كانوا يفكرون بالأولويات الآتية في عقودهم التجارية، الوقت، والأداء، والتكلفة، وبلد التصنيع، ولكن كانت أولويات السوفيت تتحرك بشكل مقلوب مع أولويات العراقيين، وهذه الخسارة كانت متعلقة أيضاً بممارسات موسكو لتصدير النفط، إذ إن النفط العراقي كان يتم تصديره مرة أخرى من طريق موسكو ولصالحها، حيث كان العراق يدفع تكاليف مشترياته وقروضه من الاتحاد السوفيتي من طريق النفط، ولكن بسعر يقل عن السعر العالمي بنسبة 30%؛ وبسبب قرار التأميم عام 1972 فقد بقيت كميات كبيرة من النفط العراقي خارج السوق، حيث اضطر العراق للاتفاق مع الاتحاد السوفيتي لتسديد أي قروض لموسكو على بغداد من طريق النفط، وأن يستمر الدفع بهذا النحو إلى ثمانينيات القرن الماضي، وقد استفاد الاتحاد السوفيتي من هذا الاتفاق استفادة كبيرة، حيث كان يحصل على النفط العراقي بسعر 3 دولارات أميركية للبرميل، وبسبب شحة النفط الخام في الأسواق العالمية، فقد كان يبيع البرميل من النفط الخام بسعر 18 دولاراً أميركياً للمستهلكين الغربيين، وفضلاً عن ذلك فقد أدّت موسكو لعبة مضادة لمنظومة أوبك، حيث كانت تبيع النفط بسعر أقل من السعر الذي كانت تطلبه منظمة أوبك وبمقدار يقارب 4 دولارات للبرميل، وكانت هذه السياسة محرجة جداً لموسكو التي كانت تشجع العرب على الاستمرار في مقاطعة الأسواق الغربية وحرمانها من النفط، بينما كانت تصدر النفط إلى تلك الأسواق، ويبدو أن هذه السياسات هي التي جعلت العراق يمانع حظر تصدير نفطه إلى البلدان الغربية، ويعدُّ العراق البلد العربي الوحيد الذي لم يلتزم بقرار المقاطعة، وأن يتجه أكثر نحو الغرب اقتصادياً، ولكن في الوقت نفسه استمر اعتماد العراق على السوفيت وبلدان أوروبا الشرقية في تطوير قطاعه النفطي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث كان الطرفانِ مرتاحينِ عبر أسلوب الدفع من طريق شحنات النفط الخام، وقد دخل الاتحاد السوفيتي كلاعب مهم في تطوير الاقتصاد العراقي، إذْ تم توقيع اتفاقيات لتوسيع إنتاج حقل الرميلة الشمالي، وبناء خط أنابيب لنقل النفط بين بغداد والبصرة، ومشاريع ري، ونقل، وطاقة، ومن أهم المشاريع الكبرى كان إنشاء محطة كهرباء ذي قار في جنوب العراق بتكلفة 88 مليون دينار عراقي، ومعمل الحديد والصلب في البصرة بتكلفة 300 مليون دينار عراقي، وقد تم دفع تكاليف أغلب هذه المشاريع بوساطة النفط، وتشير إحصائية من عام 1975 إلى أن من بين 325 مليون روبل من صادرات العراق إلى الاتحاد السوفيتي كان النفط يمثل منها 320.4 مليون روبل، وقد نما حجم التبادل التجاري بين البلدين من 49.4 مليون روبل عام 1968 إلى 322.1 مليون روبل عام 1973، ليرتفع إلى 596.2 مليون روبل عام 1975، وفضلاً عن أن الاتحاد السوفيتي، فقد أمن النفط الخام العراقي حاجة بلدان أوروبا الشرقية، وقد دخل العراق في منظمة التعاون الاقتصادي لأوروبا الشرقية بصفة مراقب عام 1975 كنتيجة لهذا الدور، ولكن توجهات العراق نحو الغرب بدت تزداد وضوحاً على الرغم من التقارب مع الاتحاد السوفيتي، ففي عام 1972 زار صدام حسين أحد أهم قادة حزب البعث ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة حينذاك باريس ووقع اتفاقاً لمدة عشرة أعوام مع شركة البترول الفرنسية التي كانت تمتلك حصة تقدر بـ23.75% في شركة النفط العراقية، تقوم من خلالها الشركة بشراء ما يعادل تلك الحصة من النفط العراقي المؤمّم حديثاً، وقامت إيطاليا بتوقيع اتفاق مع العراق استوردت بموجبه 20 مليون برميل من النفط الخام العراقي لمدة عشرة أعوام، وقد تبعت خطى البلدين كل من البرازيل وإسبانيا، وقد نجح العراق في سياسته النفطية مع موسكو وحلفائها في التخلص من آثار فرض عقوبات محتملة كانت يمكن أن تقدم عليها الشركات النفطية الغربية ضده، وقد أقدم العراق -متأثراً بزيادة إنتاجه النفطي وارتفاع الأسعار- على تسريع برنامجه للتطوير الاقتصادي؛ حيث توجه إلى الشركات الغربية بدلاً مما كان مفترضاً أن يكون عليه الأمر، ففي عام 1973 وقعت شركة النفط العراقية عقداً لبناء أرصفة لتحميل النفط في المياه العميقة، ومد أنابيب للنفط تحت الماء إلى مدينة الفاو مع شركة براون أند روت الأميركية، حيث دخلت في تنفيذ المشروع شركات ألمانية غربية، وأعطى العراق أيضاً عقد مد أنبوب لنقل النفط من حقول كركوك إلى ميناء دورتيول التركي، وزودت اليابانُ العراقَ بالأنابيب لهذا المشروع ومشروع أنابيب بصرة – بغداد، وقدمت اليابان قرضاً بمبلغ 500 مليون دولار إلى العراق للمساعدة في استكشاف النفط، وفي عام 1973 تم الاتفاق مع اليابان على قرض آخر بمبلغ مليار دولار لبناء عدة مشاريع صناعية منها إنشاء مصفاة للنفط ومجمع بتروكيمياويات ومعمل للأسمدة الكيميائية في خور الزبير. وفي إطار ما يُطلَقُ عليه “النفط مقابل الدعم” فقد وقّع العراق في عام 1974 عقداً مع إيطاليا بمبلغ 900 مليون دينار عراقي لتزويدها بالنفط العراقي مقابل مشاريع زراعية وصناعية مختلفة، وقد تمكنت بريطانيا في عام 1971 من استعادة مكانتها كأول بلد مصدر للعراق عام 1971، وعلى الرغم من التقارب بين العراق والاتحاد السوفيتي وحلفائه، إلا أن إحصائيات التبادل التجاري تشير بوضوح إلى رجحان كفة الغرب مقارنة بالشرق، حيث وصل مستوى التبادل التجاري بين العراق والغرب إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بـ183 مليون دولار مع الاتحاد السوفيتي وشركائه، ليصل إلى 8.2 مليار دولار مع الغرب مقارنة بـ 1.08 مليار دولار مع الاتحاد السوفيتي وحلفائه عام 1975، وتعدُّ فرنسا من أهم البلدان الغربية التي أدّت دوراً مهماً في تطوُّر العراق، حيث وصلت قيمة العقود بين البلدين الى 2 مليار دولار عام 1974، وأُلحِقت بـ1.4 مليار أخرى لمشاريع زراعية، وكان اهتمام العراقيين ينصب آنذاك على شراء أسلحة فرنسية متطورة مما جعل فرنسا في وقت لاحق في الموقع الثاني في تصدير السلاح والتقنيات العسكرية إلى العراق بعد الاتحاد السوفيتي، مع الطفرة في إيرادات تصدير النفط العراقي التي وصلت إلى 6 مليارات دولار عام 1974، كان العراق يُنفِقُ منها 4.5 مليارات دولار على الاستيراد، وكان تحريك الاقتصاد العراقي بهذا النحو أحد أهم المحفزات لتغيير سياسة البلد التجارية من اتفاقيات المقايضة مع الاتحاد السوفيتي وحلفائه إلى اتفاقيات تجارية مع القوى الصناعية الغربية؛ بسبب تعاظم موارد العراق من العملة الصعبة.
العلاقات ما بين 1975-1980:
يعدُّ فرانسيس فوكوياما العام 1975 قمة النفوذ السوفيتي في العراق؛ وذلك للأسباب الآتية: فقد كانت شحنات الأسلحة السوفيتية تتدفق على بغداد بأعداد كبيرة، وتدخلت موسكو لحل المسألة الكردية، وكانت العلاقات بين حزب البعث والحزب الشيوعي العراقي ودية، حيث حصل الأخير على ثلاثة مقتاعد في الحكومة العراقية، وكان الطرفان يعملان معاً في “الجبهة القومية”، وكانت علاقات وثيقة تربط حزب البعث بالحزب الشيوعي السوفيتي، ومع تأميم النفط العراقي كان على بغداد أن تعتمد على الاتحاد السوفيتي من أجل الأمور الاقتصادية والفنية.
لكن يبدو أن هذه العلاقة كانت قصيرة الأمد، ففي أواخر السبعينيات من القرن الماضي بدأ العراق ينأى بنفسه عن أن يكون تابعاً للاتحاد السوفيتي؛ لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار النفط بعد 1973 ونجاحه في إلحاق الهزيمة بالأكراد عام 1975، وقد أدى انهيار المقاومة الكردية إلى تخليص العراق من اعتماد شبه كامل على الأسلحة السوفيتية والدعم السياسي السوفيتي، ومع تقدم الأعوام بدا أن العلاقات العراقية – السوفيتية قد وصلت إلى ما يشبه القطيعة خلال الأعوام 1978-1980، ففي عام 1977 تصاعدت الخلافات بين حزب البعث والحزب الشيوعي العراقي، الذي كان يطالب بحصة أكبر في السلطة، وقد أقدم النظام حينذاك على إعدام 21 شيوعياً عراقياً بتهم الشروع بمحاولة انقلاب عام 1978، وفضلاً عن الخلافات حول التعامل مع الحزب الشيوعي العراقي فقد كانت السياسة الخارجية للعراق والاتحاد السوفيتي منقسمة حول عدد من القضايا، وشجع كل طرف أحد طرفي الصراع المسلح في إقليم أوكادين بين الصومال وأثيوبيا خلال الأعوام 1977-1978، وانتقد حزب البعث السياسة السوفيتية الخاصة بالصراع العربي – الإسرائيلي، حيث التزم الاتحاد السوفيتي بحق إسرائيل في الوجود، بينما كان العراق يدعو إلى تدميرها، وقد ساءت العلاقات إلى درجة أمرت من خلالها السلطات العراقية بنقل السفارة السوفيتية من المكان الذي كانت تقيم فيه؛ لأنه قريب من مكتب أحمد حسن البكر الرئيس العراقي السابق، ولم يغيّر السوفييت المكان إلا بعد قطع الماء والكهرباء عن المبنى. وقد تصارع البلدان حول الأحداث التي جرت في شمال اليمن وجنوبه بين عامي 1978 و1979، وتصارعا أيضاً حول الغزو السوفيتي لأفغانستان، واختلف الطرفان أيضاً حول الموقف من بروز نظام إسلامي جديد في طهران، ولكن أبقى الجانبان على مستوى علاقة هش بينهما دون أن تصل إلى درجة القطيعة، ففي الأعوام 1976 و1979 وقع العراق اتفاقيتين لاستيراد معدات عسكرية من الاتحاد السوفيتي شملتا دبابات وطائرات وأنظمة دفاع جوي وصواريخ، وأصبح بذلك أول مستورد للأسلحة السوفيتية في العالم الثالث، حيث كان خلال الأعوام 1964-1973 الخامس من بين بلدان العالم الثالث شراء للمعدات العسكرية السوفيتية، وخلال الأعوام 1974-1978 فقد صدر الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه ما قيمته 3.7 مليار دولار من الأسلحة والتجهيزات العسكرية إلى العراق، من أصل ميزانية العراق العسكرية التي كانت تبلغ 5.3 مليار دولار، وقد تم صرف المتبقي من ميزانية التسليح لشراء السلاح من عدة بلدان منها، 430 مليون دولار من فرنسا، و150 مليون دولار من ألمانيا الغربية، و70 مليون دولار من إيطاليا، و900 مليون دولار من آخرين تشمل سويسرا، والبرازيل، ويوغوسلافيا، وإسبانيا. وتشير بعض التحليلات إلى أن العراق تحوّل إلى تنويع مصادر سلاحه بسبب فشله في الحصول على أسلحة سوفيتية أثناء قمة الصراع المسلح مع الأكراد عام 1975، وما يؤكد هذا الأمر هو أن أول صفقة شراء سلاح من فرنسا تمت في عام 1974 في بداية التحرك لهزيمة الأكراد، وكان القلق الحقيقي الذي يشعره النظام آنذاك هو التهديد من إيران، وليس من الأكراد أو إسرائيل، إذْ قام الشاه بتطبيق برنامج ضخم للتسليح العسكري في إيران في بدايات سبعينيات القرن الماضي بهدف جعل إيران القوة الأكبر في المنطقة؛ ولهذا السبب استمر العراق في ملء ترسانته العسكرية وتحديثها من بدايات السبعينيات في القرن الماضي وحتى بعد توقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 مع إيران؛ وبالتالي فإن تحديث القوة العسكرية العراقية كان يتعدى مسألة الصراع مع الأكراد، وهو من أهم أسباب سعي العراق إلى تنويع مصادر سلاحه وبعيداً عن مصالح هذا الطرف أو ذاك، ولكن فك الارتباط يتطلب وقتاً طويلاً نظراً لطول أمد تزويد الأسلحة، ولكن التنويع كان واضحاً أيضاً في مجال علاقات العراق الاقتصادية مع الخارج، حيث بدأت حصة الاتحاد السوفيتي وحلفائه تتناقص في الاقتصاد العراقي، فقد انخفض استيراد العراق من موسكو وحلفائها من 24.6% في عام 1973 إلى 6.9% في عام 1979، بينما ارتفعت حصة البلدان الغربية من 50.7% إلى 77.2%، ويشير مؤشر آخر يتعلّق بمستويات الاقتراض العراقي من الاتحاد السوفيتي إلى طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الطرفين، فقد انخفضت القروض السوفيتية إلى العراق من 150 مليون روبل عام 1975 إلى 75 مليون روبل عام 1976، لتصل إلى 25 مليون روبل عام 1977، وقد ركزت المساعدات السوفيتية خلال هذه المدة على مشاريع إروائية ضخمة، مثل سد بحيرة الثرثار عام 1976، وإنشاء سدي حديثة والحبانية في غرب العراق، وقناة ري كركوك، ويبدو أن شعارات حزب البعث باشتراكيته، ومحاربته الإمبريالية سرعان ما تلاشت مع النقد الأجنبي، وحلت محلها براغماتية توجهت باتجاه الغرب بحثاً عن التكنولوجيا المتطورة والجودة في المواد والخدمات مقارنة بالاتحاد السوفيتي.
المصادر:
[1] Lehigh University
[2] Power-dependent relationships
[3] Facilitative influence
[4] Instigative influence
















